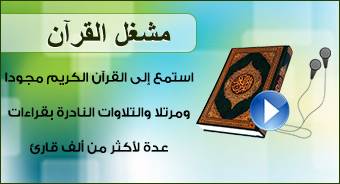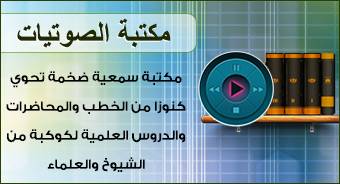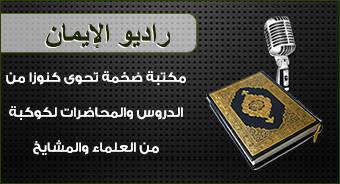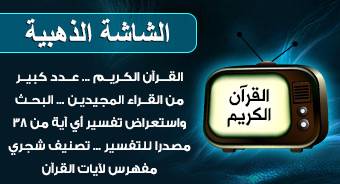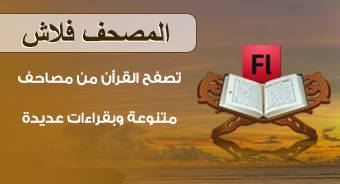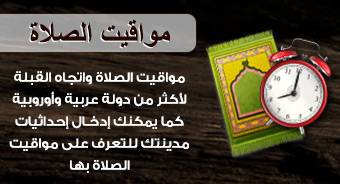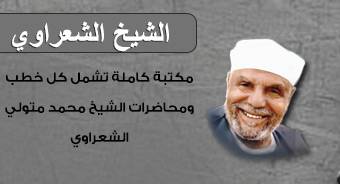|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم مقاييس اللغة ***
(قزع) القاف والزاء والعين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على خِفَّة في شيءٍ وتفرُّق. من ذلك القَزَع: قِطَع السَّحاب المتفرِّقة، الواحدة قَزَعَة. قال: تَرَى عُصَبَ القَطا هَمَلاً عليه *** كأنَّ رِعالَه قَزَع الجَهَامِ ومن الباب القَزَعُ المنهيُّ عنه، وهو أن يُحلَق رأسُ الصبيّ ويترك في مواضعَ منه شعرٌ متفرِّق. ورجلٌ مقزَّع: لا يُرَى على رأسه إلاَّ شعيرات. وفرسٌ مقزَّع: رقَّت ناصيتُه. ومن الباب في الخِفّة: تقزَّعَ الفرسُ: تهيَّأَ للرَّكض. والظَّبيُ* يَقزَع، إذا أسرَعَ. والقَزَع: صِغار الإبل. (قزل) القاف والزاء واللام كلمةٌ واحدةٌ، وهي القَزَل، وهو أسوأ العَرَج. يقال منه قَزِل يَقْزَل. (قزم) القاف والزاء والميم كلمةٌ تدلُّ على دناءةٍ ولؤم. فالقَزَم: الدَّناءة واللُّؤم. والرجل قَزَم، يقال ذلك للأنثى والذَّكر، والواحد والجمع. (قزب) القاف والزاء والباء، فيه من طرائف ابن دريد: القَزَب الصَّلاَبة والشِّدَّة. قَزِب الشيءُ: صَلُب. (قزح) القاف والزاء والحاء أُصَيلٌ يدلُّ على اختلاطِ ألوانٍ مختلفة وتشعُّب في الشَّيء. من ذلك القَزْح: التَّابَلُ من توابل القِدر. يقال: قَزِّحْ قِدْرَك. قال ابن دريد: ومنه قولهم: مليح قَزِيحٌ. ويقال: إنَّ القُزَح: الطَّرَائق، في التي يقال لها: قَوْسُ قُزَح، الواحدة قُزْحَة. ويقال: تقزَّحَ النبتُ، إذا انشَعَب شُعَباً. وشجرةٌ متقزِّحة. وقَزَح الكلبُ ببوله. وقال ابن دريد: يقال إنَّ القَزْح: بَوْلُ الكلب. والله أعلم.
(قسط) القاف والسين والطاء أصلٌ صحيح يدلُّ على معنَيَين متضادَّين والبناءُ واحد. فالقِسط: العَدل. ويقال منه أقْسَطَ يُقْسِط. قال الله تعالى: {إنَّ اللهَ يُحبُّ المُقْسِطِين} [المائدة 42، الحجرات 9، الممتحنة8]. والقَسْط بفتح القاف: الجَور. والقُسوط: العُدول عن الحق. يقال قَسَطَ، إذا جار، يَقْسِطُ قَسْطاً. والقَسَط: اعوجاجٌ في الرِّجلين، وهو خلاف الفَحَج. ومن الباب الأوّل القِسْط: النَّصيب، وتَقَسَّطْنا الشَّيءَ بيننا. والقِسْطَاس: المِيزان. قال الله سبحانه: {وَزِنُوا بالقِسْطاسِ المُستَقِيم} [الإسراء 35، الشعراء 182]. ومما ليس من هذا القُسْط: شيءٌ يُتَبَخَّرُ به، عربيٌّ. (قسم) القاف والسين والميم أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدهما على جمالٍ وحُسن والآخر على تجزئة شيء. فالأوّل القَسَام، وهو الحُسْن والجمال، وفلانٌ مُقَسَّم الوجه، أي ذو جمالٍ. والقَسِمة: الوجه، وهو أحسن ما في الإنسان. قال: كأنَّ دنانيراً على قَسِماتهِمْ *** وإنْ كان قد شفَّ الوجوهَ لقاءُ
والقَسام، في شعر النابغة: [شِدة الحَرّ]. والأصل الآخر القَسْم: مصدر قَسَمت الشّيءَ قَسْماً. والنَّصيب قِسمٌ بكسر القاف. فأمَّا اليمين فالقَسَم. قال أهلُ اللغة: أصل ذلك من القَسَامة، وهي الأيمان تُقْسَم على أولياء المقتول إذا ادَّعَوْا دمَ مقتولهم على ناسٍ اتَّهموهم به. وأمسى فلانٌ متقسَّماً، أي كأنَّ خواطرَ الهموم تقسَّمَتْه. ومما شذَّ عن هذا الباب: القَسَاميّ، وهو الذي يَطْوِي الثِّيابَ أوّل طيِّها، ثم تُطْوَى على طَيِّه. قال: * طيَّ القَسَامِيّ بُرودَ العَصَّابْ * يقال إنَّ العصّاب: الغَزَّال. (قسن) القاف والسين والنون كلمةٌ تدلُّ على شِدّة. يقال: اقسأَنَّ اللَّيلُ: اشتدَّ ظلامُه. والمقسَئنُّ: الصُّلب من الرجال، ويكون كبيرَ السِّنّ. قال: إنْ تكُ لَدْناً ليِّناً فإنّي *** ما شئتَ من أشْمَطَ مقسَئِنِّ (قسي) القاف والسين والحرف المعتل يدلُّ على شِدَّة وصلابة. من ذلك الحجر القاسي. والقَسْوة: غِلَظ القَلْب، وهي من قسوة الحَجَر. قال الله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كالحِجَارَةِ أوْ أَشَدُّ قَسْوةً} [البقرة 74]. [و] القاسية: اللَّيلة الباردة. ومن الباب المُقاساة: معالجَة الأمر الشَّديد. وهذا من القَسوة، لأنَّهُ يُظهِر أنّه أقسَى من الأمر الذي يُعالِجهُ. وهو على طريقة المُفاعَلة. (قسب) القاف والسين والباء يدلُّ على مِثْل ما دلَّ عليه الذي قبله. يقولون: [القَسْب]: التَّمر اليابس. قال: وأسمَرَ خَطِّيّاً كأنَّ كعوبَه *** نَوَى القَسبِ عَرَّاصاً مُزَجّاً منصّلا والقَسْب: الصُّلب من كلِّ شيء. والقَسِيب: الطَّويل الشَّديد. ومن* الباب القَسِيب، وهو صوتُ الماءِ في جرَيانه، ولا يكون صوتٌ إلاّ كان بقوة. قال عَبِيد: * للماء مِن تحتِهِ قَسيبُ * (قسر) القاف والسين والراء يدلُّ على قَهرٍ وغلَبَة بشدة. من ذلك القَسْر: الغَلَبة والقَهْر. يقال: قْسَرتهُ قسراً، واقتسرتُه اقتِساراً. وبعيرٌ قَيْسَرِيٌّ: صُلْب. والقَسْوَرة: الأسد، لقُوّته وغلَبته.
(قشع) القاف والشين والعين أصل صحيحٌ واحِد، أومأ إلى قياسِه أبو بكر فقال: "كلُّ شيءٍ خَفَّ فقد قَشِع وقَشَع يقْشَع قَشَعاً، مثل اللحم يجفف". وهذا الذي قاله صحيح. ومنه انقشَعَ الغَيم وأقشع وتَقَشَّع، والقِشْعة: القطعة من السَّحاب تَبقَى بعد انكشاف الغَيم. وذكر بعضُهم أنَّ الكُناسة قَُِشع. قال الكِسائيّ، قَشَعت الرِّيح السحابَ وانقشَعَ هو. وأقْشَعَ القومُ عن الماء، إذا أقلعوا. ويقال إنَّ القِشَعَ: ما يُرمى به عن الصَّدر من نُخَاعَة. والقَشْع: ما قُشِع عن وجه الأرض. وكَلأٌ قشِيعٌ: متفرِّق. وشاةٌ قَشِعَةٌ: غَثَّةٌ، كأنَّ السِّمَن قد انقشَعَ عنها. ورجلٌ قَشِعٌ: لا يثبت على أمر. فأمّا القَشْع فيقال: بيتٌ من أَدَم، والجمع قُشُوع. قال: * إذا القَشْعُ من رِيح الشِّتاء تَقعقَعا * وهو القياس، لأنَّهم إذا سارُوا قَشَعوه. ويقال: القَشْع: النِّطْع. وهو ذلك القياس. (قشف) القاف والشين والفاء كلمةٌ واحدةٌ، وهي قولهم: قَشِف يَقْشَفُ، إذا لوَّحته الشمس فتغيَّر، ثمَّ قِيل لكلِّ من لا يتصنَّع للتجمُّل قَشِف، وهو يتقشَّف. (قشب) القاف والشين والباء أصلانِ يدلُّ أحدُهما على خَلْط شيءٍ بشيء، والآخَر على جِدَّةٍ في الشيء. فالأوَّل: القَشْب، وهو خَلْط الشَّيء بالطَّعام، ولا يكاد يكون إلاّ مكروها. من ذلك القِشْب، هو السمُّ القاتل. قال الهُذَليّ: فَعَمَّا قليلٍ سقاها معاً *** بذِيفان مُذْعِفِ قِشْبٍ ثُمالِ ويقال: قَشَب فلانٌ فلاناً بسُوءٍ، ذكَره به أو نسَبَه إليه. وقَشَبَه بقبيحٍ: لَطَخَه به. ورجل مُقشَّب الحسَب، إذا مُزِج حسبُه. قال ابن دريد: القِشْبَة: الخسيس من النّاس، لغة يمانِيَة. والأصل الآخَر: القَشِيب: الجديد من الثِّياب وغيرِها. والقَشيب: السَّيف الحديث العهد بالجِلاء. (قشر) القاف والشين والراء أصلٌ صحيح واحد، يدلُّ على تنحيةِ الشّيء ويكونُ الشيءُ كاللِّباس ونحوه. من ذلك قولك: قشَرت الشَّيء أقشره. والقِشْرة: الجلدة المقشورة. [والقِشْر]: لباس الإنسان، قال الشاعر: [مُنِعَتْ حنيفةُ واللهازمُ منكمُ *** قِشرَ العراقِ وما يَلَذُّ الحنجرُ] وفي [حديث] قَيْلَةَ: "كنت إذا رأيتُ رجلاً ذا رُواء وذا قِشْرٍ طمَحَ بصري إليه". والمَطْرة القاشرة: التي تَقشِر وجهَ الأرض. وسنةٌ قاشورة: مُجْدبة تَقْشِر أموالَ القوم. قال: فابعَثْ عليهم سنةً قاشورهْ *** تحتلق المالَ احتلاقَ النُّورهْ ثم سمِّي كلُّ شيءٍ يَفْعَل ذلك قاشوراً، فيقولون للشُّؤم: قاشور. ويقولون في المثل: "أشأَم مِن قاشِر"، وهو فحلٌ له حديث. ولهذا سُمِّي الفِسْكِل من الخيل الذي يَجيء في الحَلْبة آخِرَها قاشُوراً. وقولهم إنَّ الأقْشَر: الشَّديد الحُمرة، وإنَّما ذلك للشَّديد حُمرةِ الوجه، الذي يُرَى وجهُه كأنَّه يتقشّر. وقُشَيرٌ: [أبو قبيلة] من العرب. (قشم) القاف والشين والميم أُصَيلٌ إن صحّ فهو من الأكل وما ضاهاه من المأكول. قالوا: القَشْم: الأكل. والقُشَام: ما يُؤكَل. وقال ابن دريد: "قُشَام المائدة: ما نُفِض منها من باقي خُبز وغيرهِ". ويقال: ما أصابت الإبِلُ مَقْشَماً، أي لم تُصِب ما ترعاه. ومما شذَّ من هذا الباب إنْ صحَّ قولُهم: قَشَمت الخُوصَ، إذا شقَقتَه، لتَسفَّهُ. وكلُّ ما شُقَّ منه فهو قُشَام.
(قصع) القاف والصاد والعين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تطامُنٍ في شيء أو مطامَنةٍ له. من ذلك القَصْعَة، وهي معروفة، سمِّيت بذلك للهَزْمة. والقاصِعاء: أوَّل جِحَرة اليَربوع، وقياسُها ما ذكرناه. وقد تقَصَّع، إذا دخلَ قاصِعاءَه. قال: فوَدَّ أبو ليلى طُفيلُ بنُ مالكٍ *** بمُنعَرَجِ السُّوبان لو يَتَقَصَّعُ فأمَّا قَصْع النّاقة بجِرّتها فقالوا: هو أن ترُدَّها في جوفها. والماء يَقْصَعُ العطش: يقتلُه ويذهبُ به. قال: * فانصاعَتِ الحُقْبُ لم تُقْصَع صَرائِرُها * وقصَعتُ ببُسْط كَفِّي هامتَه: ضربْتُها. وقَصَعَ الله به، إذا بَقِيَ قمِيَّاً لا يَشِبُّ ولا يزداد، وهو مقصوعٌ وقصيعٌ. (قصف) القاف والصاد والفاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على كسرٍ لشيء. ولا يُخْلِف هذا القياسُ. يقال: قصَفت الرِّيحُ السفينةَ في البحر. وريحٌ قاصف. والقَصِف: السَّريع الانكِسار. والقَصِيف: هشيم الشَّجر. ومنه قولُهم: انقصفوا عنه، إذا تركوه. وهو مستعار. والأقْصَف: الذي انكسرت ثَنِيَّتُه من النِّصف. ورعدٌ قاصف، أي شديد. وقياس ذلك كأنَّه يكاد يَقصِف الأشياءَ بشدَّته. يقولون: بَعثَ الله تعالى عليهم الرِّيحَ العاصف، والرّعدَ القاصف. ومنه القَصْف: صَرِيف البَعير بأسنانه. فأمَّا القَصْف في اللَّهو واللَّعِب فقال ابنُ دريد: لا أحسبه عربيَّاً. وليس القَصْف الذي أنكَرَه ببعيدٍ من القياس الذي ذكرناه، وهو من الأصوات والجَلَبة. وقياسه في الرَّعد القاصف، وفي صَريف البَعير بأسنانِه. (قصل) القاف والصاد واللام أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على قطعِ الشيء. فالقَصْل: القَطْع. يقال قَصَله، إذا قطَعَه. والقَصِيل معروف، وسمِّي بذلك لسُرعة اقتصاله، لأنَّه رَخْص. وسيف مِقْصَلٌ: قطّاع، وكذلك القَصَّال. ولسانٌ مِقْصَل على التشبيه. والقِصْل: الرَّجْل الضّعيف، لأنَّه منقطِع. فأمَّا القُصَالة فما يُعْزَل من البُرِّ ليُداسَ ثانيةً، فإن كان صحيحاً فقياسُه قريب. (قصم) القاف والصاد والميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على الكسر. يقال: قصَمْت الشيء قَصْماً. والقُصَم: الرّجُل يَحطِم ما لَقي. وقال الله تعالى:{وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظالِمَةً} [الأنبياء 11] أراد –والله أعلمُ- إهلاكَه إيّاهم، فعبَّر عنه بالكسر. والقَصِيمة والقَيْصوم: نبتان. (قصو/ي) القاف والصاد والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلُّ على بُعدٍ وإبعاد. من ذلك القَصَا: البُعْد. وهو بالمكان الأقصَى والنَّاحيةِ القُصوَى. وذهبتُ قَصا فلانٍ، أي ناحيته. ويقال: أحاطُونا القَصَا. أي وقفوا منّا بين البعيد والقريب غير أنَّهم مُحِيطون بنا كالشَّيءِ يَحُوط الشَّيءَ يحفظه. قال: فحَاطُونا القَصَا ولقد رأونا *** قريباً حيثُ يُستَمَع السِّرارُ
وأقصَيتُه: أبعدتُه. والقَصِيّةُ من الإبل: المودوعة الكريمة لا تُجهَد ولا تُرْكَب، أي تُقصَى إكراماً لها. فأمَّا النّاقةُ القَصْواء فالمقطوعة الأذُن. وقد يمكن هذا على أنَّ أذنَها أُبعِدَت عنها حين قُطعت. ويقولون: قصَوتُ البعيرَ فهو مقصُوٌّ: قطعت أذنَه. وناقةٌ قَصْواء، ولا يقال بعيرٌ أقصَى. (قصب) القاف والصاد والباء أصلان صحيحان، يدلُّ أحدهما على قَطْع الشّيء، ويدلُّ الآخَر على امتدادٍ في أشياءَ مجوَّفة. فالأوّل القَصْب: القَطْع؛ يقال قَصَبْته قَصْباً. وسمِّي القصَّابُ قصّاباً لذلك. وسيف قَصَّابٌ، أي قاطع. ويقال: قَصَبْتُ الدّابةَ، إذا قطعتَ عليه شُربَه قبل أن يَرْوَى. ومن الباب: قَصَبت الرّجُل: إذا عبتَه، وذلك على معنى الاستعارة. والأصل الآخر: الأقصاب: الأمعاء، واحدها قُصْب. والقَصَب معروف، الواحدة قَصَبة. والقَصْباء: جمع قَصَبة أيضاً. والقَصَب: أنابيبُ من جوهر. وفي الحديث: "بَشِّرْ خَدِيجةَ ببيتٍ في الجَنّة من قَصَب، لا صَخَب فيه ولا نَصَب". والقَصَب: عُروق الرّئة. والقَصَب. مخارِجُ الماء من العيون؛ وهذا على معنى التشبيه. والقُصّاب: المَزَامير. قال: وشاهِدُنا الجُلُّ والياسَمِيـ *** ـنُ والمُسمِعاتُ بقُصَّابِها ومن الباب القَصائِب: الذوائب، واحدتها قَصِيبة. ويقال القُصَّابة: الخُصْلة من الشَّعر. (قصد) القاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثة، يدلُّ أحدها على إتيانِ شيءٍ وأَمِّه، والآخَر على اكتنازٍ في الشيء. فالأصل: قصَدته قَصْداً ومَقْصَداً. ومن الباب: أقْصَدَه السَّهمُ، إذا أصابه فقُتِل مَكانَه، وكأنّه قيلَ ذلك لأنَّه لم يَحِد عنه. قال الأعشى: فأقْصَدها [سهمي] وقد كان قبلها *** لأمثالها من نِسوَةِ الحيِّ قانِصَا ومنه: أقْصَدَتْه حَيَّةٌ، إذا قتلَتْه. والأصل الآخر: قَصَدْت الشيءَ كسرته. والقِصْدَة: القِطْعة من الشيء إذا تكسَّر، والجمع قِصَدٌ. [ومنه قِصَدُ] الرِّماح. ورمحٌ قَصِد، وقد انقَصَد. قال: ترى قِصَدَ المُرّانِ تُلْقَى كأنَّها *** تذرُّعُ خُِرصانٍ بأيدِي الشَّواطبِ والأصل الثالث: الناقة القصيد: المكتنِزة الممتلِئة لحماً. قال الأعشى: قطعتُ وصاحِبي سُرُحٌ كِنازٌ *** كرُكْنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةٌ قَصيد ولذلك سمِّيت القصيدةُ من الشِّعر قصيدةً لتقصيد أبياتها، ولا تكون أبياتُها إلاَّ تامَّة الأبنية. (قصر) القاف والصاد والراء أصلانِ صحيحان، أحدهما يدلُّ على ألا يبلُغَ الشّيءُ مدَاه ونهايتَه، والآخر على الحَبْس. والأصلان متقاربان. فالأوّل القِصَر: خلافُ الطُّول. يقول: هو قَصيرٌ بيِّن القِصَر. ويقال: قصَّرتُ الثَّوبَ والحبلَ تَقصيراً. والقَصْر: قَصْر الصّلاة: وهو ألاَّ يُتِمّ لأجل السّفَر. قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} [النساء 101]. والقُصَيْرى: أسفل الأضلاع، وهي الواهنة. والقُصَيْرى: أفْعَى، سمِّيت لقِصَرها. ويقال أقْصَرت الشَّاةُ، إذا أسنَّتْ حتَّى تقصُرَ أطرافُ أسنانها. وأقصَرت المرأة: ولدت أولاداً قِصاراً. ويقال: قصَّرتُ في الأمرِ تقصيراً، إذا توانيت، وقصَرْت عنه قُصوراً: عَجَزت. وأقصرت عنه إذا نزعتَ عنه وأنت قادرٌ عليه. قال: لولا علائقُ من نُعْمٍ عَلِقْتُ بها *** لأقْصرَ القلبُ مِنِّي أيَّ إقصارِ وكل هذا قياسُه واحد، وهو ألاّ يبلُغَ مدَى الشّيء ونهايتَه. والأصل الآخر، وقد قلنا إنهما متقاربان: القَصْر: الحبس، يقال: قَصَرْتُه، إذا حبستَه، وهو مقصور، أي محبوس، قال الله تعالى: {حُورٌ مَقْصُوراتٌ في الخِيَامِ} [الرحمن 72]. وامرأةٌ قاصِرَة الطَّرف: لا تمدُّه إلى غيرِ بَعلِها، كأنَّها تحبِس طرْفَها حَبْساً. قال الله سبحانه: {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ} [الرحمن 56]. ومن الباب: قُصارَاك أن تفعَلَ كذا وقَصْرُكَ، كأنَّه يراد ما اقتصرت عليه وحَبَسْتَ نفسَك عليه. والمقاصر: جمع مقصورة، وكلُّ ناحيةٍ من الدار الكبيرة إذا أحيط عليها فهي مقصورة. وهذا جائزٌ أن يكون من القياس الأوَّل. ويقولون: فرسٌ قَصِيرٌ: مقرَّبة مُدْناةٌ لا تُترك تَرود، لنَفاستها عند أهلها. قال: تراها عند قُبَّتِنا قصيراً *** ونبذُلُها إذا بَاقَتْ بَؤُوقُ
وجارية قَصِيرةٌ وقَصُورةٌ من هذا. والتِّقصار: قلادةٌ شبيهة بالمِخْنَقة، وكأنَّها حُبِست في العُنق. قال: ولها ظبيٌ يؤرِّثها *** جاعلٌ في الجِيد تِقصارَا ومن الباب: قَصْر الظَّلامِ، وهو اختلاطُه. وقد أقبلَتْ مَقاصر الظَّلام، وذلك عند العشيّ. وقد يمكن أنْ يُحمَل هذا على القياس فيقال: إنَّ الظَّلامَ يَحبِس عن التصرُّف. ويقال: أقصَرْنا، إذا دخلْنا في ذلك الوقت. ويقال لذلك الوقت المَقْصَرة، والجمع مَقاصر. قال: فبعثتُها تَقِص المَقاصِر بعدما *** كَرَبتْ حياةُ النّار للمتنوِّرِ ومما شذَّ عن هذا الباب القَصَر: جمع قَصَرة، وهي* أصلُ العُنق، وأصل الشجرة، ومُستغلَظُها. وقرئت: {إنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كالْقَصَرِ} [المرسلات 32]. والقَصَر: داءٌ يأخذ في القصَر. والله أعلم.
(قضع) القاف والضاد والعين أصلٌ صحيح، وقياسه القهر والغلَبة. قالوا: القَضْع: القَهْر. قال الخليل: وبذلك سمِّيت قُضاعة. وذكر ناسٌ أنّ قَضاعة سمِّي بذلك لأنَّه انقضع عن قومِه، أي انقطع. فإن كان هذا صحيحاً فهو من باب الإبدال، تكون الضّاد مبدلةً من طاء. وقال ابن دريد: "تقضَّع القومُ: تفرّقوا". وهذا من الإبدال أيضاً. (قضف) القاف والضاد والفاء أُصَيلٌ يدلُّ على دِقَّة ولطافة. فالقَضَف: الدِّقَّة؛ يقال عُودٌ قَضِف وقَضِيفٌ. وجمع قضيف قِضاف. ومنه القَضَفة، والجمع قُِضْفان: قطعةٌ من رمل تنْقضِفُ من معظمه، أي تنكسر. (قضم) القاف والضاد والميم كلمتانِ متباينتان لا مناسبةَ بينهما: إحداهما القَضْم: قَضْم الدَّابَّة شعيرَها؛ يقال قَضِمَتْ تَقْضَم. ويقولون: ما ذُقتُ قَضَاما. ويقال: القَضْم: الأكل بأطراف الأسنان، والخَضْم بالفم كلِّه. والكلمة الأخرى: القضيم، يقال إنَّه الجِلدُ الأبيض، أو الصَّحيفة البيضاء. قال النابغة: كأنَّ مَجرَّ الرامساتِ ذُيولَها *** عليه قَضِيمٌ نمَّقتهُ الصَّوانعُ (قضي) القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: {فقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ في يَوْمَيْنِ} [فصلت 12] أي أحكَمَ خَلْقَهنّ. ثم قال أبو ذؤيب: وعَليهما مَسرودتانِ قَضاهما *** داودُ أو صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ والقضاء: الحُكم. قال الله سبحانه في ذكر من قال: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} [طه 72] أي اصنَعْ واحكُمْ. ولذلك سمِّي القاضي قاضياً، لأنَّه يحكم الأحكامَ ويُنْفِذُها. وسمِّيت المنيَّةُ قضاءً لأنَّه أمر يُنْفَذُ في ابن آدم وغيرهِ من الخَلْق. قال الحارث ابن حِلِّزة: وثمانونَ من تميمٍ بأيديـ *** ـهِمْ رماحٌ صُدورهنَّ القضاءُ أي المنيّة. وكلُّ كلمةٍ في الباب فإنَّها تجري على القياس الذي ذكرناه، فإذا هُمِز تغيَّر المعنى. يقولون: القَـُضْأة: العيب، يقال ما عليك منه قُضأةٌ وفي عينه قـَُضْأةٌ، أي فَساد. (قضب) القاف والضاد والباء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قطْعِ الشَّيء. يقال: قَضَبْتُ الشيءَ قَضْبا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا رأى التَّصليب في ثوبٍ قَضَبَه، أي قطعه. وانقضَب النَّجمُ من مكانه. قال ذو الرُّمَّة: كأنَّه كوكبٌ في إِثْرِ عِفْرِيَةٍ *** مُسوَّمٌ في سَواد اللَّيلِ منقضِب والقضيب: الغُصْن. والقَضْب: الرَّطْبة، سمِّيت لأنَّها تُقْضَب. والمَقَاضب: الأرَضُون تنبت القَضْب. وقَضَبت الكرم: قطعتُ أغصانَه أيّامَ الرَّبيع. وسيفٌ قاضِبٌ وقضيب: قطّاع. ورجلٌ قَضّابةٌ: قطَّاعٌ للأمور مقتدِرٌ عليها. وقُضَابة الكرم: ما يتساقط من أطرافه إذا قُضِب. ومن الباب: اقتَضَبَ فلان الحديثَ، إذا ارتَجَله، وكأنَّه كلامٌ اقتطعَهُ منْ غير روِيّة ولا فِكْر. ويستعارُ هذا فيقال: ناقةٌ قضيب، إذا رُكِبَتْ قبلَ أن تُراض. وقد اقتضبتها. وقَضيب: واد. والله أعلم.
(قطع) القاف والطاء والعين أصلٌ صحيحٌ واحد، يدل على صَرْمٍ وإبانة شيءٍ من شيء. يقال: قطعتُ الشيءَ أقطعه قَطْعاً. والقطيعة: الهِجران. يقال: تقاطَعَ الرّجُلان، إذا تصارما. وبعثَتْ فلانةُ إلى فلانةَ بأُقطوعةٍ، وهي شيءٌ تبعثُه إليها علامةً للصَّريمة. والقِطْع، بكسر القاف، الطَّائفة من اللَّيل، كأنَّه قِطعةٌ. ويقال: قطعت قَطْعاً.*وقطعتِ الطير قُطوعاً، إذا خَرَجَتْ من بلاد [البرد إلى بلاد] الحرِّ، أو من تلك إلى هذه. والقَطِيع: السَّوط. قال الأعشى: * تراقِبُ كفِّي والقَطِيعَ المحرَّما * وأقطعتُ الرّجُلَ إقطاعاً، كأنَّه طائفةٌ قد قُطِعت من بلَد. ويقولون لليائس من الشيء: قد قُطِعَ به، كأنَّه أملٌ أمّله فانقطع. وقَطعتُ النهرَ قُطوعاً، إذا عبرتَه. وأقطعتُ فلاناً قُضباناً من الكَرْم، إذا أذِنْتَ له في قطعها. والقضيب: القطيع من الشجرة تُبْرَى منه السِّهام، والجمع أقْطُع. قال الهُذليّ: ونميمةً من قانصٍ متلبِّبٍ *** في كفِّه جَشْءٌ أجشُّ وأقْطُعُ وهذا الثَّوبُ يُقطِعُك قميصاً. ويقال: إنَّ مقطِّعة النِّياط: الأرنب، فيقال إنما سمِّيت بذلك لأنَّها تَقطَع نِياطَ ما يتْبعها من الجوارح في طلبها. ويقال: النِّياط: بُعْد المفازة. ومن الباب: قطَّع الفرسُ الخيلَ تقطيعاً: خلّفها ومضَى، وهو تفسير الذي ذكرناه في مقطِّعة النِّياط، إذا أُريد نياط الجارح. ويُزاد في بنائه فيقال: جاءت الخيل مُقْطَوْطِعاتٍ، أي سراعاً. ويقولون: جاريةٌ قطيعُ القِيام. كأنَّها من سِمَنها تنقطع عنه. وفلانٌ منقطِعُ القَرين في سَخاءٍ أو غيره. وفي بعض التَّفسير في قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ بسَبَبٍ إلى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ} [الحج 15]. إنَّه الاختناق، والقياس فيه صحيح. ومُنْقَطَع الرَّمل ومَقْطَعُه: حيثُ ينقطع. والقَطِيع: القِطعة من الغَنَم. والمقطَّعات: الثِّيَاب القِصار. وفي الحديث: "أنَّ رجلاً أتاه وعليه مقطَّعات له"، وكذلك مقطَّعات أبيات الشِّعر. والقُطْع: البُهرْ. ومقاطع الأودية: مآخيرها. وأصاب بئرَ فُلانٍ قُطْع، إذا نَقَص ماؤُها. والقِطع بكسر القاف: الطِّنْفِسَة تُلقى على الرَّحل؛ وكأنَّها سمِّيت بذلك لأنَّ ناسجَها يقطعُها من غيرها عند الفَرَاغ، كما يسمَّى الثَّوب جديداً كأنَّ ناسجَه جَدَّه الآن. والجمع قُطُوع. قال: أتَتْكَ العِيسُ تنفُخُ في بُراها *** تَكشَّفُ عن مَناكبها القطوعُ والقِطْع: النَّصل من السِّهام العَريض، كأنَّه لما بُرِيَ قُطِع. ومما شَذَّ عن هذا الباب القُطَيعاء: [ضربٌ من التَّمر. قال]: [باتوا يعشُّون القُطيعاءَ] ضيفَهم *** وعندهم البَرْنِيُّ في جُلَل ثُجْلِ (قطف) القاف والطاء والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على أخْذِ ثمرةٍ من شجرة، ثم يستعار ذلك، فتقول: قَطَفت الثمرة أقْطِفُها قَطْفاً. والقِطْف: العُنقود. ويقال: أقطَفَ الكَرْم: دنا قِطافُه. والقُطَافة: ما يسقُط من القُطوف. ويستعار ذلك فيقال: قَطَف الدّابَّةُ يَقطِف قَطْفاً، وهو قَطوفٌ، كأنَّه من سرعة نَقْلهِ قوائمَه يقطِفُ من الأرض شيئاً. وقد يقال للخَدْشِ: قَطْف؛ والمعنى قريب. [قال]: * ولكن وجْهَ مولاك تقطِفُ * (قطل) القاف والطاء واللام أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قطع الشّيء. يقال: قَطَله قَطْلاً، وهو قَطِيلٌ ومقطول. ونخلةٌ قطيل، إذا قُطعت من أصلها فسقطَتْ. ويقال: إنَّ القَطِيلة: القطعة من الكساء والثَّوبِ يُنْشف بها الماء. والمِقْطَلة: حديدة يُقطَعُ بها، والجمع مَقاطل، ويقال إنَّ أبا ذؤيبٍ الهذليَّ كان يلقَّب "القطيل". (قطم) القاف والطاء والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على قطع الشيء، وعلى شهوة. فالقَطْع يعبَّر عنه بالقَطْم. يقولون: قَطَم الفصيلُ الحشيشَ بأدنى فمه يَقطِمه. وقطَامِ: اسمٌ معدول، يقولون إنَّه من القَطْم. وهو القَطْع. وأمَّا الشَّهوةُ فالقَطَم. والرَّجُل الشَّهوانُ اللَّحم قَطِم. والقُطَامِيُّ: الصَّقر، ولعلَّه سمِّي بذلك لحِرصه على اللحم. وفحلٌ قَطِم: مشتَهٍ للضِّرابِ. (قطن) القاف والطاء والنون أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على استقرارٍ بمكان وسكون. يقال: قَطَن بالمكان: أقام به. وسَكَنُ الدّارِ: قطينُهُ. ومن الباب قَطِينُ المَلِك، يقال هم تُبّاعه، وذلك أنّهم يسكنون حيثُ يسكن. وحَشَمُ الرّجل: قَطِينُه أيضاً*. والقُطْن عندنا مشتقٌّ من هذا لأنَّه لأهل المَدَرِ والقاطنين بالقُرى. وكذلك القِطْنيَّة واحدة القَطَانيّ كالعَدَس وشبهِه، لا تكون إلاَّ لقُطّان الدُّور. ويقال للكَرْم إذا بدَتْ زَمَعاتُه: قد قَطَّن؛ كأنَّ زَمَعَاتهِ شُبِّهَتْ بالقُطْن. ويقال إنَّ القَطِنة، والجمع القَطِن: لحمة بين الوَرِكين. قال: * حتَّى أتى عارِي الجآجِي والقَطِنْ * وسُمِّيت قَطِنة للزومها ذلك الموضع، وكذلك القَطِنة، وهي شِبْه الرُّمَّانة في جَوْفِ البقرة. (قطو) القاف والطاء والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلُّ على مقاربَةٍ في المشي. يقال: القَطْو: مُقارَبَة الخطو، وبه سمِّيت القطاة، وجمعها قطاً. والعرب تقول: "ليس قَطَاً مثلَ قُطَيّ"، أي ليس الأكابرُ مثل الأصاغر. قال: ليسَ قَطاً مثلَ قُطَيٍّ ولا الـ ***ـمَرْعيُّ في الأقوام كالرَّاعي وسمِّيت قطاةً لأنَّها تَقْطُو في المِشْية. ويقولون: اقطَوْطَى الرَّجلُ في مشيته؛ استدار. ومما استُعير من هذا الباب القطاة: مَقعَد الرَّدِيف من ظَهْر الفَرَس. (قطب) القاف والطاء والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على الجمع. يقال: جاءت العربُ قاطبةً، إذا جاءت بأجمعِها. ويقال قطَبْتُ الكأسَ أقطِبُها قطباً، إذا مزجتَها. والقِطَاب: المِزاج. ومنه قولهم: قَطَب الرّجُلُ ما بين عينَيه. والقطِيبة: ألوان الإبل والغنم يُخلَطان. ومن الباب القُطب: قُطب الرَّحَى، لأنَّه يجمع أمرَها إذْ كان دَوْرُه عليها. ومنه قُطْبُ السَّماء، ويقال إنَّه نجمٌ يدور عليه الفَلَك. ويستعار هذا فيقال: فلانٌ قطبُ بني فلانٍ، أي سيِّدُهم الذي يلوذون به. ومما شذَّ عن هذا الباب القُطْبة: نَصْلٌ صغير تُرمَى به الأغراض، فأمَّا قولُهم: قَطَبت الشَّيءَ، إذا قطعتَه، فليس من هذا، إنَّما هو من باب الإبدال، والأصل الضّادُ قضبت، وقد فسّرناه. (قطر) القاف والطاء والراء هذا بابٌ غير موضوع على قياس، وكلمهُ متباينةُ الأصول، وقد كتبناها. فالقُطر: النّاحية. والأقطار: الجوانب، ويقال: طعَنَه فقطَّره، أي ألقاه على أحد قُطْرَيه، وهما جانباه. قال: قد علِمَتْ سلمى وجاراتُها *** ما قَطَّرَ الفارسَ إلاَّ أنا والقُطُرْ: العُود. قال طَرفة: وتنادَى القومُ في نادِيهمُ *** أقُتارٌ ذاك أم ريح قُطُرْ والقَطْر: قَطْر الماءِ وغيرهِ. وهذا بابٌ ينقاس في هذا الموضع، لأنَّ معناه التتابُع. ومن ذلك قِطَار الإبل. وَتَقاطرَ القومُ، إذا جاؤوا أرسالاً، مأخوذٌ من قِطار الإبل. والبعيرُ القاطرُ: الذي لا يزالُ بَوْلُه يقطُر. ومن أمثالهم: "الإنْفاض يُقَطِّر الجَلَبَ"، يقول: إذا أنْفَضَ القومُ أي قلّت أزوادهم وما عِندَهم قَطَّرُوا الإبلَ فجلبوها للبيع. والقَطِرانُ، ممكنٌ أنْ يسمَّى بذلك لأنَّه مما يَقطُر، وهو فَعِلان. ويقال: قَطَرت البعيرَ بالهِناء أقطُرُهُ. قال: * كما قَطَر المَهْنُوءةَ الرّجلُ الطَّالي * ومما ليس من هذا القياس، القِطْر: النُّحاس. وقولهم: قَطَرَ في الأرض، أي ذهَبَ. واقطَارَّ النَّباتُ، إذا قاربَ اليُبْس.
(قعل) القاف والعين واللام ثلاثُ كلماتٍ غيرِ متجانسةٍ ولا قياسَ لها. فالأولى القُعَال: ما تناثَر من نَور العِنَب. والثانية: القَواعل: رؤوس الجبال، واحدتُها قاعلة. والثالثة القَعْوَلَى: مِشيةٌ يَسفِي ماشِيها التُّرابَ بصُدور قدمَيه. (قعم) القاف والعين والميم كلماتٌ لا ترْجِع إلى قياسٍ واحد، لكنَّها متباينة. يقولون: أُقْعِم الرّجلُ، إذا أصابَه داءٌ فقتَلَه. وأقْعَمَتْه الحيّة. والقَعَم: مَيَلٌ في الأنف. ويقال إنَّ القَعَم في الأَليتينِ: ارتفاعُهما، لا تكونان مُسترخِيتين. ويقولون: القَيعَم: السِّنَّور. (قعن) القاف والعين والنون ليس فيه إلاَّ قُعَين: قبيلةٌ من العرب. (قعو) القاف والعين والحرف المعتل فيه كلماتٌ لا قياسَ لها. يقولون: قَعَا الفحلُ النّاقةَ قُعُوَّاً. والقَعْو: خشبتانِ في البَكْرةِ فيهما المِحْور.*قال: مَقذوفةٍ بدَخيسِ اللّحمِ بازِلُها *** له صريفٌ صَرِيفَُ القَعْوِ بالمَسدِ وأقْعَى الرَّجلُ في مَجلِسه، إذا تسانَدَ كما يُقعِي الكلِب. ونُهِيَ عن الإقعاء في الصلاة. وذكر ابنُ دُريد: امرأةٌ قعواء: دقيقةُ السّاقَين. (قعث) القاف والعين والثاء أُصَيلٌ يدلُّ على كثرة. يقولون: القَعِيث: المطر الكثير، والسَّيْب الكثير، وأقْعَثَ له العطيَّة: أجزلَهَا. (قعد) القاف والعين والدال أصلٌ مطّرِدٌ منقاسٌ لا يُخلِف، وهو يُضاهِي الجلُوسَ وإن كان يُتكلَّمُ في مواضعَ لا يتكلَّم فيها بالجُلوس. يقال: قَعَد الرَّجلُ يقعُد قعوداً. والقَعْدة: المرَّة الواحدة. والقِعدة: الحالُ حسنةً أو قبيحة في القعود. ورجلٌ ضُجَعةٌ قُعَدة: كثيرُ القعودِ والاضطجاع. والقَعِيدة: قَعِيدة الرَّجُل: امرأتُه. قال: لكنْ قعيدةُ بيتها مجفوةٌ *** بادٍ جناجنُ صدرِها وبها جَنَا وامرأة قاعدةٌ، إن أردتَ القعود، وقاعدٌ عن الحيض والأزواج، والجمع قواعد. قال الله تعالى: {وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً} [النور 60]. والمقْعَدات: الضَّفادع. والقُعْدُد: اللّئيم، وزِيدَ في بنائه لقعوده عن المكارم. وأمَّا القُعْدَد والقُعدُد فهو أقربُ القوم إلى الأب الأكبر. وفلانٌ أقْعَدُ نَسَباً، إذا كان أقربَ إلى الأب الأكبر، وقياسُهُ صحيحٌ لأنَّه قاعد مع الأب الأكبر. والقَعيد من الوحش: ما يأتيك من ورائك، وهو خِلافُ النَّطيح مُستقبِلك. والقَعَد: القَومُ لا ديوانَ لهم، فكأنَّهم أُقعِدُوا عن الغَزْو. والثَّدي المُقْعَد على النّهد: النّاهد، كأنّه أُقْعِد في ذلك المكان. وذو القَعْدة: شهرٌ كانت العربُ تَقعُد فيه عن الأسفار. والقُعْدة: الدَّابّة تُقتَعَد للرُّكوب خاصة. والقَعُود من الإبل كذلك. ويقال القَعِيدة: الغِرارة، لأنَّها تُملأُ وتُقعَد. والقَعِيد: الجرادُ الذي لم يَستو جناحُه. وقواعد البيت: آساسُه. وقواعد الهَوْدَج: خشباتٌ أربع مُعترِضاتٌ في أسفله. والإقعادُ والقُعَاد: داء يأخذ الإبلَ في أوراكها فيُمِيلها إلى الأرض. والمُقْعَدة من الآبار: التي أُقعِدَتْ فلم يُنْتَهَ بها إلى الماء وتُرِكَت. والمُقْعَد: فَرْخُ النَّسر. وقَعَدَتِ الرَّخَمة، إذا جَثَمت. والمَقاعِد: موضع قُعودِ النّاسِ في أسواقهم. والقُعُدات: السُّروج والرِّحال. فأمَّا قولهم: قَعِيدَكَ الله، وقَعْدَكَ الله، في معنى القَسَم..…. (قعر) القاف والعين والراء أصلٌ صحيحٌ واحد، يدلُّ على هَزْمٍ في الشّيء ذاهبٍ سُفْلاً. يقال: هذا قَعر البئر، وقَعر الإناء، وهذه قصعةٌ قَعِيرةٌ. وقَعَّر الرّجلُ في كلامه: شَدَّق. وامرأة قَعِرة: نعتُ سَوءٍ في الجِماع. وانقَعَرت الشّجرة من أرومتِها: انقلعَتْ. (قعز) القاف والعين والزاء ليس فيه إلا طريفةُ ابن دريد، قال: قَعَزْتُ الإناءَ: ملأتُه. وقَعَزْتُ في الماء: عبَبْتُ. (قعس) القاف والعين والسين أصلٌ صحيح يدلُّ على ثباتٍ وقوّة، ويتوسَّعون في ذلك على معنى الاستعارة، فيقال للرّجل المنيع العزيز: أَقْعَس، وللغليظ العُنق قَوْعَس. [و] الأقعسانِ: جبلان طويلان. وليلٌ أقعَسُ، أي طويلٌ ثابت، كأنه لا يكاد يَبْرَح. والإقعاس: الغِنى والإكثار. وعِزّةٌ قَعساء: ثابتةٌ لا تزول أبداً. [قال]: * وعزّةٌ قَعساءُ لَن تُناصَى * والعزُّ الأقعس في المذكَّر. ومما حُمِل على هذا: القَعَس: دُخولُ العنقِ في الصّدر حتَّى يَصير خلافَ الحَدَب، لأنَّ صدرَهُ كأنَّه يرتفع. يقال: تقاعَسَ تقاعُساً، واقعَنْسَسَ اقعنساساً. قال: بئسَ مُقامُ الشّيخِ أمرِسْ أمرِسِ *** إمَّا على قَعْوٍ وإمَّا اقعَنْسِسِ (قعش) القاف والعين والشين أُصَيلٌ يدلُّ على انحناء في شَيء. يقال قَعشْتُ رأسَ الخشبة كيما تُعطَف إليك*. وقَعَشت الشّيءَ: جمعتُه. وهو ذلك القياس، لأنَّك تَعطِفُ بعضَه على بعض، وتَقَعْوَشَ الرّجلُ، إذا انحنَى. وكذلك الجِذع. والقُعُوشُ: مراكب النساء، الواحد قَعْشٌ. (قعص) القاف والعين والصاد أصلٌ صحيح يدلُّ على داءٍ يدعو إلى الموت. يقال: ضربَه فأقْعَصَه: أي قَتَله مكانَه. والقَعَصْ: الموت الوَحيّ. ومات فلانٌ قَعَْصا. والقُعَاص: داءٌ يأخذ في الصَّدر كأنَّه يكسِر العنُق، يقال قُعِصت فهي مقعوصة. (قعض) القاف والعين والضاد كلمةٌ تدلُّ على عَطْف شيءٍ وحَنْيِه. من ذلك القَعْض: عطفُك رأسَ الخشبة، كما تُعطَف عروش الكَرْم. وهو قولُه: * أطرَ الصَّناعَين [العريشَ] القَعْضا * (قعط) القاف والعين والطاء أصلٌ صحيح يدلُّ على شَدِّ شيء، وعلى شِدَّة في شيء. من ذلك الاقتِعاط، وهو شدُّ العِصابة والعمامة. يقال: اقتعطتُ العمامةَ، وذلك أن يشدَّها برأسه ولا يجعلَها تحتَ حنكِه. وفي الحديث: "أمَرَ بالتلحِّي ونَهَى عن الاقتعاط". ويقولون: القَعَط: الغضب وشدّة الصياح. والقَعْط: الضِّيق. يقال: قَعّط على غريمه: ضَيَّق. ومما شذَّ عن هذا القَعْط: الشاء الكثير. (قعف) القاف والعين والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على اجتراف شيءٍ وأخْذِهِ أجمع. من ذلك القَعْف، وهو شدة الوطء واجتراف التّرابِ بالقوائم. والقاعف: المطر الشديد يَجْرُف وجهَ الأرض. وسيلٌ قُعَافٌ، مثل الجُراف. وقَعَفْتُ النّخلةَ، إذا قلعتَها من أصلها. والقَعْف: اشتِفافُكَ ما في الإناء أجْمَعَ.
|